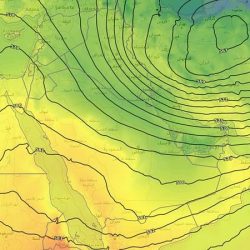أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري المسلمين بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، فمن أخذ بالتقوى وخالف النفس والهوى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى مراتب الإحسان ارتقى، وسعد في الدارين ونجا.
وقال في خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام: “من تمام نعمة الله على عباده أن نصب لهم للحق منارات وبينات، من الدلائل والآيات، يهتدي إليها من وفقه رب الأرض والسماوات؛ فمن أطلق نظره في الكون وتفكر، وأمعن النظر في كتاب الله وتدبر، علم أن الله خلق الناس على الفطرة السوية، ودلهم عليه بالآيات الكونية، وأرسل إليهم الرسل بالحجج القوية، فسهل لعباده الساعين إلى مرضاته سبيلا فأقروا له بالعبودية، وحذر سبحانه من عصيانه النفوس الغوية”.
وأضاف: “إخلاص العبادة لله وإقامة الدين، وصية الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقد وصى بذلك نوحًا وإبراهيم، وعيسى وموسى الكليم، ومحمدًا خاتم النبيين والمرسلين، وقد تضافرت الآيات في ترسيخ هذا المعنى إعادة وتأكيدًا، فما من رسول بعث في أمة إلا وقد صدر دعوته بهذا الأصل العظيم قال تعالى؛ (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)”.
وأكد “الدوسري” أن نصوص الوحيين دلت على عظم أمر التوحيد، وكونه أصل الأعمال وأساسها، فإن وجد قبلت، وإن عدم تبددت، كما بينت أن الشياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم وتغويهم عن دين الله وإخلاص العبادة له، وقد أقسم إبليس على ذلك كما حكى الله عنه في كتابه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: “إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا” .
وأوضح أن أول نداء للناس أجمعين، في كتاب الله المبين: هو قول رب العالمين: يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.. ففي قوله تعالى: اعبدوا ربكم إثبات للتوحيد، وفي قوله: أفلا تجعلوا لله أندادًا نفي للشرك، وقد تكرر هذا الأسلوب في الذكر الحكيم، فبدأ الله خطابه جل وعلا بإثبات التوحيد الخالص له، وختمه بنفي الشرك المنزه عنه؛ توجيها للعباد إلى تحقيق الأمرين، والجمع بين المتلازمين. وهذا هو معنى “لا إله إلا الله”، فكونوا عباد الله من أهلها الذين حققوا شروطها، فأثبتوا ما أثبتت، ونفوا ما نفت، ووحدوا الله في ربوبيته وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته بلا تمثيل ولا تكييف، ولا تحريف ولا تعطيل.
وأشار خطيب الحرم المكي إلى أن الله عز وجل امتن على عباده بما سخره لهم في السماوات والأرض من نعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة، مما ينتفعون به في حياتهم حالاً ومآلاً، حيث ذكر سبحانه قرار العالم، وهو الأرض، وسقفه وهو السماء، وأصول المنافع وهو الماء الذي أنزله من السماء، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون، فتأملوا هذه النتيجة، وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها فالتوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه؛ وانتظام خلق السماوات والأرض قائم على التوحيد.
وذكر أن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وإنابتهم، ليست بأقل من حاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقهم، وأن افتقارهم إليه في معافاته لأبدانهم، وستره لعوراتهم، وتأمينه لروعاتهم، ليس بأعظم من حاجتهم إليه في توفيقهم لطاعته وإعانتهم على شهواتهم، بل حاجتهم إلى محبته والإنابة إليه، والعبودية له أعظم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة من خلقهم، وهو المطلب الأفخم لإيجادهم، فلا نجاح ولا صلاح ولا فلاح للعباد إلا بالتوحيد وإقامة الدين، واجتناب الشرك، فالشرك هو أعظم أمر نهانا الله عنه.
وشدد “الدوسري” على أن الشرك نوعان: شرك أكبر، لا يغفره الله عز وجل، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة من دعاء وذبح ونذر وسجود وخضوع وغير ذلك مما لا يصرف إلا لله، وشرك أصغر، وهو ما أتى في النصوص أنه شرك، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كالرياء، والحلف بغير وأنه لما كان القرآن معدن التوحيد ومنبعه، ومصدر الإيمان ومرجعه، نفرت منه نفوس من أشربوا في قلوبهم الأنداد، وضرب الهوى بينهم وبين الهدى أصلب الأسداد، فكانوا في أحكامهم عليه في أمر مريج، فكروا وقدروا فلم يتمخض جهدهم إلا عن رأي خديج، وقد تحداهم الله جل في علاه أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، وفي دائرة الإبلاس انحجزوا، فاستولى العجز على بيانهم، وأحاط بهم العي من كل جوانبهم ثم حسم الباري جل وعلا نتيجة التحدي بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكفرين.
وأردف أن هذا الترتيب القرآني البديع دال على أن أعظم مصدر لمعرفة التوحيد: هو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وقد برهن ابن القيم رحمه الله على هذا التقرير بقوله: “كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد وإنه ليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد والنبوات، ورد النحل الباطلة، والآراء الفاسدة، مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه”. انتهى كلامه رحمه،، فمن تحدى هذا القرآن، فقد باء بالخسران، وتدهده في دركات الخذلان، وحكم عليه بالهوان، فالقرآن الكريم معجز في ألفاظه وتراكيبه، معجز في نظمه وأساليبه، معجز في خطاباته وأحكامه ومضامينه، معجز في حججه وبراهينه.
وبين خطيب الحرم المكي أن الله قد وعد عباده الموحدين وبشرهم بجنات تجري من تحتها الأنهار، فنعم عقبى الدار، وتوعد من أشرك به غيره، وخالف أوامره، وارتكب نواهيه بعذاب النار فبئس القرار وقال إن في وعد الله للموحدين الممتثلين لأوامره بالجنة تحفيزًا عظيمًا على امتثال ما شرع الله وأمر، وعونًا كبيرًا للكف عما نهى عنه وزجر وإن القرآن الكريم والسنة النبوية لحافلان بوصف الجنة التي هي موعود الله لعباده الموحدين الطائعين، فالجنة دار الأمن والسلام، لا غل ولا تدابر ولا خصام، دعوى المؤمنين فيها: سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، لا نصب فيها ولا صخب، ولا يخرج أهلها منها ولا يمسهم التعب، بل هي حبور وسرور، لا خوف فيها ولا حزن ولا ثبور إنه الفوز العظيم، الذي لا فائدة من فوز دونه ولا طائل، وكل ظفر سواه فمتاع غرور وظل زائل، كما أن الخسارة العظمى دخول النار، فهي دار البوار: نسأل الله العافية والنجاة من النار، ونسأله أن يجعل الجنة مأوانا مع المتقين الأبرار.





























 (
( (
(